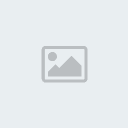إن إتقان اللغة الأجنبية لا يتم إلا على حساب اللغة الأم لغة العرب، ومع اللغة تدخل المُثُل التي يريدها الأعداء، فضلاً عن الإتقان الضائع على حساب لغة القرآن.
ولا يقول عاقل أو مخلص: بتعليم اللغة الأجنبية للأطفال ونترك تعليمهم الفصحى لتشيع العامية وينتشر اللحن بين الناشئة. ( والوقت المناسب لدراسة اللغة الأجنبية يكون عادة في سن المراهقة أو قبلها بقليل، و ذلك عندما يبدأ الناشئ يهتم بالعالم الخارجي، وبالأقوام الذين يعيشون خارج وطنه ممن لهم به صلة في تاريخ أمته القديم أو الحديث...
ففرنسا وإنجلترا ومعظم دول أوربا لا تعلّم في المرحلة الأولى إلا لغة الطفل القومية ) [1].
( وقد أدرك الإنكليز وأمثالهم أن التربية الإسلامية أكبر خطر على الاستعمار، ولكنهم لم يجابهوها بالعنف والإكراه، وإنما عمدوا إلى إفسادها من الداخل باسم الإصلاح والتحديث. ومن النقط الأساسية التي أصبحت تحدد إطار التربية في البلاد المختلفة.. فرض لغة المستعمر، واستعمال كل الوسائل التي تؤدي إلى ضياع لغة البلاد الأصلية.. ). [2]
وقد فطن ابن خلدون إلى مضار الجمع بين لغتين أو علمين فيقول: ( ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم: أن لا يخلط على المتعلم علمان معاً، فإنه حينئذ قلَّ أن يظفر بواحد منها لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معاً ويستصعبان، ويعود منهما بالخيبة ) [3].
والذي نلمسه بوضوح أن الإنكليز وكل الدول المستعمرة يحاولون أن يجعلوا لغتهم لغة التعليم أينما حلُّوا، وقد أورد الدكتور محمد أمين المصري - رحمه الله - من كلام أبي الحسن الندوي قوله: ( وإن الاهتمام الزائد باللغات الأجنبية، وإعطاءها أكثر من حقها - يجعلها تنمو على حساب اللغة العربية. وإن تدريس عدة لغات في وقت ما قد أصبح موضع بحث عند خبراء التعليم خصوصاً في المراحل الابتدائية والمتوسطة ). [4] فما بالك - أيها القارئ الكريم - بَمن هم دون تلك المراحل ؟ ممن لم يتقنوا النطق الجيد بلغتهم بعد، ثم يُطلب منهم معرفة لغة أقوام آخرين ؟ !.
ومن الغرائب أن بدعة حديثة أصبحت تغزو المدارس الخاصة في ديار المسلمين، إذ يخصص لمادة اللغة الإنجليزية مثلاً أربع حصص في الأسبوع وأين ؟ وفي أي مستوى ؟ في رياض الأطفال، وسن التمهيدي، أي قبل السنة الأولى من المرحلة الابتدائية. وصار يعتبر ذلك معياراً لجودة هذه المدارس، بسبب إقبال الأهالي ورغبتهم ثم المتاجرة بهذه الرغبات.
إن تعلم لغة أخرى لضرورة ملحة، أو أمر طارئ - لا غبار عليه؛ فزيد بن ثابت - رضي الله عنه - كان في الحادية عشرة من عمره، لما قدم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - المدينة المنورة، وكان يكتب العربية ويروي عن نفسه فيقول: ( أُتِيَ بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدمه المدينة، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، وقد قرأ مما أُنزل عليك سبع عشرة سورة، فقرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعجبه ذلك، وقال: يا زيد تعلّم لي كتاب يهود؛ فإني - والله - لا آمنهم على كتابي. قال: فتعلَّمته فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته ) [5] نلاحظ هنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلب من زيد أن يتعلم لغة اليهود بعد أن حذق اللغة العربية كتابة، وحفظ من القرآن الكريم ما حفظ. أما أن يعلم أطفال المسلمين لغة أجنبية - وهم لا يتقنون لغتهم نطقاً أو كتابة - فهذا لا يقوله عاقل أو منصف. ونستفيد من هذا الحديث أيضاً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يختار في تربيته الشخص المناسب للمكان المناسب، فعلينا ألا نبدد الطاقة الحية، والكفاءة الممتازة، ونفوّت بذلك مصلحة من مصالح المسلمين.
وهاهو واقع المسلمين يشهد بأن الطاقات تهدر، وفي أبناء هذه الأمة العباقرة والممتازون، لأمر أو لآخر، مما لا يُرضي الله، ولا ينسجم مع مصلحة المسلمين. وكثيراً ما نضع الشخص غير المؤهل لمنصب لا يصلح له، ولسان الحال يقول: ( ليس بالإمكان أحسن مما كان ).
ونحن لا نتحدث هنا عن أبناء المسلمين في ديار غيرهم، فهؤلاء يعانون من الضغوط عليهم - هم وأهلوهم - الكثير، والحاجة هنالك ماسة لوجود مؤسسات تربوية تصون لغة الجيل الثاني وعقيدته، وقد اضطر هؤلاء غالباً أن يعيشوا في تلك الديار مكرهين، أعانهم الله وسدد خطاهم نحو الخير.
وأخيراً نختم هذه الفقرة بقول ابن تيمية - رحمه الله -: ( وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه، إذا اُحتِيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة.. وإنما كرهه الأئمة إذا لم يُحْتَجْ إليه ). [6]

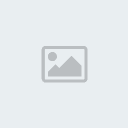 السلام عليكم اختي الزائره
السلام عليكم اختي الزائره 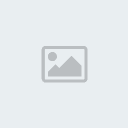


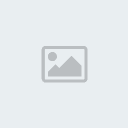 السلام عليكم اختي الزائره
السلام عليكم اختي الزائره 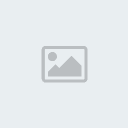


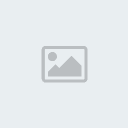 السلام عليكم اختي الزائره
السلام عليكم اختي الزائره